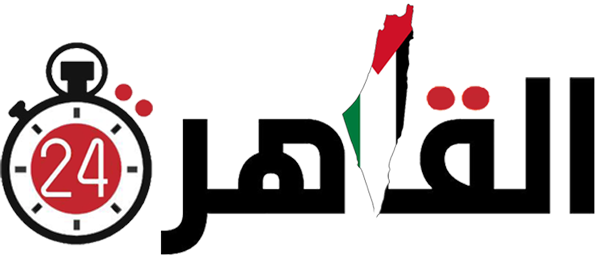"برويطة"
قُمت من نومي والكون يسبل جفنه على عينه المُبصرة، وأخذت أفتح عيني المُسبلتين اللتين لم تذوقا طَعم الغَمض طوال الليل، حيث كانت الأفكار تتضارب في رأسي وتتصارع في حِيرة تَملكت من كل جوارحي، وظلّت الأفكار تتوافد وتتداعى على رأسي المُنهك من تفكير مُعقد، فلا يختفي مشهد إلاّ ليقوم مكانه مشهد آخر في نفس السياق ألا وهو سياق العُمر والذكريات. جَمعت كل مُقتنيات الطفولة ووضعتها على مكتبي في مشهدٍ درامي مملوء بالحنين، كاميرا فوتوغرافية قديمة تعمل بالأفلام ، إنسان آلي يعمل بالبطاريات، راديو قديم ونظارة تعرض مزارات ومناسك الحج عند الضغط عليها،بعض العُملات القديمة وطوابع وخطابات ورقية كانت بيني وبين أمي، ومُصحف أمي - رحمة الله عليها - والذي كانت تقرأ منه وردها اليومي.
فاضت الابتسامة المُرتسمة على شفتيَّ في نفس الوقت الذي انسدلت فيه دمعة من عينّي، لا أدري هل هو الحنين إلى ماضِ جميل أم غوص في ذكرى استشعرت من خلالها بوجودي وكياني، وكأني أعيش غريب في دنيا لا تُشبهني. التأرجح بين البسمة والدمعة يُشبه إلى حد بعيد اللحظات الفاصلة بين الواقع والخيال، هي لحظات التأرجح أيضاً بين اليقظة والحلم، أو ربما هو حلم اليقظة الذي طالما هربنا فيه من واقع أليم سيطر على تلك الحُفرة العميقة التي سكنت أعماق أعماق عقلنا الباطن حتى أصبحنا نعيش في كوابيس مُستمرة يقال أنها انعكاس لما تشعر به أرواحنا العميقة المُستترة.
تذكرت حينها كيف لسيدة عظيمة أن تُسافِر إلى أقاصي مشارق الأرض، وتدفع في تلك الأسفار من عُمرها وأعصابها حتى تضمن لأولادها الصِغار مستقبلاً يليق بهم كما تمنت، وتذكرت كيف لطِفل أن يعيش حياة مملوءة بالأنشطة الثقافية والرياضية بفضل أم واعية مُثقفة وهبت حياتها لِصغارها عندما قررت أن تستثمر فيهم كل ما ادخرته طوال عمرها.
كُنت أظن في بداية الأمر أن تجربة الغُربة لسيدة في مُنتصف العمر تجربة تُعد سهلة أو على الأقل بدون عقبات كثيرة، حتى جاءتني فُرصة مُماثلة بعد أكثر من خمسة وعشرين عاماً من تجربة سفر أمي – رحمة الله عليها – وكانت وجهتي إلى دولة مُجاورة لأعمل بها مديراً في أحد المتاحف الثقافية، ولكن بعد أقل من إثنين وعشرين يوماً قررت العودة إلى مصر معترفاً بقوة وصلابة وعظمة أمي مُنحنياً لها، ورافعاً كل قُبعات التقدير والإحترام.
احتلت ذهني مشاهد بناء منزلنا الجديد والذي تم بناؤه بعد عودة أمي من سفرها في مُنتصف التسعينات. وقفزت إلى ذهني صورة مدرستي الإبتدائية التي كانت تعمل بها أمي مُدرِّسة لغة عربية وتربية ودينية، وتذكرت عندما زارتني في فصل 3/2 لتطمئن عليّ من بعيد، ولكني عند رؤيتي لها، ناديت عليها بفرحة طفل فخور بأمه: أمي .. أمي .. أنا هُنا ! وفجأة وجدتها تصفعني على وجهي وتقول لي: هُنا لا تقل لي أمي .. أنا هنا المُعلمة وأنت تلميذي مِثل أي تلميذ وأشارت بيدها نحو باقي الفصل.
وقفت برهة مُتخشباً من الذعر، انظر بعينين مُتسعتين إلى أمي ولم أستطع أن أرد عليها في لحظتها، لأن دهشتي أخرستني، وقبل أن أعثر على لساني لأنطق، همهمت هي بصوت خافت: أنت بخير يا أحمد ؟ لا تزعل مني أرجوك!
مرت فترة من الوقت ثقيلة ضجرة، وأخيراً حل موعد الإنصراف من المدرسة. كنت أستعجل الذهاب إلى المنزل حتى اسأل أمي لماذا صفعتيني ؟! وعندما رجعت إلى المنزل وجدتها تنتظرني في شوق ولهفة وتقول لي: يا بني عاهدت نفسي أن أعدل بين تلاميذي وخشيت أن أجرح مشاعر أحدهم إذا سمحت لك أن تناديني بـ أمي وسط الفصل، هناك فرق بين المدرسة والمنزل!
أدركت كل شيء في هذه اللحظة، وظل هذا الدرس محفوراً في ذاكرتي استدعيه في تعاملاتي مع طُلابي عندما أدخل إحدى محاضراتي في الجامعة.