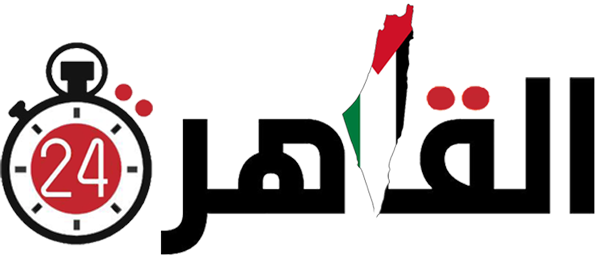وقائع مهمة غير رسمية للبحث عن آميتاب باتشان في الهند!
(1)
لم تكد الطائرة تحلق فوق العاصمة الهندية "نيودلهي"، حتى وافانا قائدها عبر مكبرات الصوت، أنه يتعذر الهبوط في مطار "آنديرا غاندي" بسبب الضباب الذي يتشابك فوق سماءها، وعليه سنتوجه في هبوط اضطراري لمطار حيدر آباد جنوبا، والذي يبعد نحو 1200 كيلومتر عن النقطة التي نحن عليها الآن.
سيمنعني الضباب أيضا من مغادرة العاصمة "دلهي" وسيؤخر رحلتي قرابة 5 ساعات، لكن بين الهبوط الاضطراري في الوصول، والانتظار الإجباري لدى المغادرة، لم يكن الشخص الذي ذهب هو ذاته الذي عاد.
ومن ثم فإن تبرمي من تأخري عن وجهتي (تبرم ممزوج بلهفة الاستكشاف).. قد تبدل بشيء من الأناة والتصالح مع حقيقة أن دخولك الهند هو قرارك الخاص.. لكن خروجك منها قرارها هي!

والضباب هنا، وهو يؤخر الطائرات عن مواعيد إقلاعها وهبوطها، ليس حادثا مناخيا قدريا بمقدار ما هو جزء من الهند وأزماتها وسحرها ولامعقوليتها، فهو يبسط نفوذه بحيث لم أر الشمس ساطعة- في أيام يناير- إلا في حدود الثانية ظهرا!
وهو جزء من التلوث البيئي الذي يحكي ما تنفثه الأرض نحو السماء في هذه البقعة من الكوكب، بحيث صار طابعا لدلهي كلها وجزءً من الجدل الدائر حول الحياة فيها، إذ تتعطل من حين لآخر بعض الخدمات لأن طبقات الضباب سامة في بعض المناطق.
وإذا أردت أن تفهم الضباب عليك أن تفهم الهند، وإذا أردت أن تفهم الهند عليك أن تحاول فهم الإنسان ذاته.. بهواجسه القديمة بذاته العميقة وما ينطمر تحت طبقات الوعي في تاريخه الجمعي.
حتى لقد أحسست نفسي في مفاوضات مع الإله شيفا والإلهة كريشنا، حتى يتركاني أذهب من أرضهما، بوصفهما من الأرواح الطوافة في هذه الأرض، أو على أقل تقدير بوصفهما من "الأفكار" التي تهيمن على قرابة سدس سكان كوكب الأرض، ومن ثم تتولد لديهم قوة ما على الفعل، أو صلاحية ما له، أو هكذا فكرت بعدما تغذى جسمي بالأكل الهندي ذي البهارات الزاعقة، وبعدما تنفست هواءها وزرت معابدها، البوذي والهندوسي والسيخي منها. فأضحت كيميائي الداخلية على نحو ما هندية، ومن ثم نظامي السيكولوجي الداخلي.

فحتى بعد عودتي منها ولمدة نحو خمسة أيام متتالية، كنت أحلم ومسرح أحداث أحلامي هو الهند. كأن عقلي ووجداني مأسوران هناك، ولم يغادرا مع جسدي لدى العودة للقاهرة.
كدت أجن في اليوم الرابع من عودتي، فما هذا الذي يحدث في يومي؟ لماذا ألتقي أصدقائي في أحلامي في طرقات نيودلهي؟ بينما سريري الذي أنام عليه في محافظة الجيزة؟.
إلى أن وافيت تقريرا في الجارديان البريطانية عن كتاب لطبيب نفسي يحكي عن تجاربه في علاج الذين سافروا الهند ثم علقوا نفسيا فيها، وبدوا كفئران وقعت في مصيدة الهند للأبد، بلوثات عقلية مختلفة! فمنهم من أخذ يطوف بلا توقف داخل مدن الهند ومنهم من ذهب طواعية للسجن في إحدى ولاياتها ومنهم من اتزن بعد خلل ومن اختل بعد توازن.. والقصص كثيرة ومدهشة.
انزعجت انزعاجا شديدا أن أكون أحد هؤلاء الذين يحمل عنوان القطعة الصحفية قصتهم " مسافرون فُقدا للأبد: لماذا يقع بعض السائحين في متلازمة الهند؟"
ناهيك أنني أخذت أقلل كميات الملح في الطعام منذ عودتي للقاهرة، تكفيرا عن كمية البهارات الهندية التي على جسمي أن يتخلص منها، لعله يتنصل من كيمياء الهند وأسطورتها التي سكنت مفاصله وتلافيف عقله.
(2)
فور الهبوط في نيودلهي، كنت قد غيرت تماما مهمتي التي ذهبت لأجلها.
فقد كان جدول مواعيدي متخما بلقاءات مع صناع الإعلام من قرابة عشرة دول كالهند واليابان وبريطانيا وروسيا وغانا وإندونيسيا و..و...و..، وأخطط وسط كل هذا لزيارات خاطفة لمعالم الهند. ما أمكن.
وفجأة تحولت المهمة ذات الطابع الجاد التي أضحيت فيها أشبه برجال الأعمال في الأفلام الأمريكية حين يهبطون من الطائرات، بحواسيبهم المحمولة، متوجهين لناطحات سحاب شاهقة حيث الاجتماعات الكوكبية، والعروض المزودة بالصور والإحصاءات، وحيث الأداء السينمائي المفتعل حول "اتفاق ما" يود الجميع إبرامه.
فجأة تحول كل هذا- بسبب رسالة نصية تلقيتها- إلى هامش على متن ما أود القيام به حقا، وما قررت الارتجال في سبيله، موجها الدفة إلى اتجاه آخر.
وأضحت مهمتي الجديدة هي البحث عن "آميتاب باتشان"!

ففور أن علم أحد الأصدقاء بوصولي الهند، أرسل لي رسالة ممازحة، لكن تملؤها مسحة من تلهف طفولي حقيقي غير مصطنع " سلم لي على آميتاب باتشان".
جاءتني الرسالة وأنا داخل الأنبوب الموصل من مخرج الطائرة لساحة المطار، فانشغلت بها تماما بينما أقطع المسافة حتى ضابط الجوازات.
فقد ذكرني صديقي ذو الأصول الريفية بمطلع التسعينيات حين كانت المقاهي المصرية تعرض أفلام "آميتاب باتشان" عبر أجهزة الفيديو، وتمتلئ المقاهي في المدن والأرياف بجمهور المشاهدين العريض.
ثم تداعت أمام عيني ذكريات فقرة الفيلم الهندي في برنامج التلفزيون المصري أيام الأعياد، حين كانت العائلة المصرية تجتمع قبل نحو ربع قرن أو يزيد لتشاهد فيلما هنديا يبدأ في الظهيرة وينتهي مع أذان العشاء أحيانا!.
ثم طافت بذهني أشهر هذه الأفلام التي كان محورها الأصيل هو الصراع بين الخير والشر.. الخير المحض والشر البحت.
وكان آميتاب باتشان هو "البطل" بمواصفاته الشعبية المقبولة بامتداد الكوكب، الطول الفارع، الوجه الوسيم، خفة الظل، القدرة على ضرب الخصوم، الآلة الصوتية المرحة متى تطلب الأمر والشجنة متى اقتضى السياق.
بملابس من الجينز المتاح في أسواق العالم كله، دون تزين بالغ أو تأنق من هذا الذي لا يستطيع المشاهد تحمل كلفته كما هو حال ملابس بطل كـ "جيمس بوند" مثلا.
ثم سألت نفسي.. كيف يمكن تفكيك "شفرة" أفلام آميتاب باتشان التي سلبت لب المصريين لعقد من الزمان على الأقل؟
لم أسع لمقابلة النجم العالمي الذي ماتزال صوره تتصدر الإعلانات في قلب العاصمة الهندية، فمحاولة فهمه وفهم ما قدم لنا، كان أشد تعقيدا من فكرة السعي وراءه.

(3)
بدا لي الألم الذي يصاحب لوح الكتف الأيمن من جسمي منذ سنوات وقد خف بعض الشيء، بعدما تعرضت لجلسة علاجية، وفق المبادئ الطبية للـ"آيروفيدا"، وهي علاج تقليدي هندي قديم، يقوم ضمن ما يقوم على تدليك مواضع الألم والمعاناة بمجموعة من الزيوت والمواد الطبيعية.
حين خف الألم بعض الشيء كان قد تكون لدي انطباع جازم بأن الهند ليست ككل بلاد الله حقا.
فأول حوار أجريته في نيودلهي كان على طاولة الطعام مع رجل في نهاية العقد السابع من العمر، في فندق لا يبعد كثيرا عن مطار "آنديرا غاندي"، وقد قال لي الرجل بكل عادية وبساطة أن روحه غادرت جسمه لبعض الوقت وطافت ذات اليمين وذات الشمال، وأن هذه الممارسات الروحية التأملية شائعة جدا.. وأن الرهبان فوق قمم الجبال يطوفون العالم بينما تجلس أجسادهم في وضعيات تأمل صامتة قد تمتد لشهور طوال!.
حين قال لي الرجل الوقور الذي يرتدي ملابس غربية بحتة تنتمي لعلامات تجارية غربية هذا الكلام، تذكرت على الفور أنني قبل سفري قرأت طرحا طريفا مفاده أنه عليك في الهند أن تتأهب للتعامل مع متناقضات شتى دون أن ينفجر رأسك، وأن نضج الإنسان النفسي يقاس بقدرته على الاحتفاظ بفكرتين متناقضتين دون أن ينفجر رأسه!.
أخذت أتأمل الرجل الذي لو قيل لي قبل سفري إلى هناك أنني سألتقي رجلا مسنا يحكي لي عن تجربته في تحريك وتطويف روحه خارج جسده، لتخيلته عاري الصدر بلحية بيضاء طويلة وجسد أسمر نحيل، يجلس في وضعية اليوجا تحت شجرة باسقة، وغالبا تخضع حوله الأفيال البيضاء في سكينة بالغة.
لكن المفارقة أن الرجل، الذي أدى أدوارا عملية فيما بعد في إدارة الفعالية التي ذهبت لأجلها، كان يرتدي جينز أمريكي وملابس غربية ويتحدث الإنجليزية بطلاقة وينطلق بين الحضور كمواطن عولمي بارّ. ويجلس معي على طاولة طعام فندق ذي نجوم خمس.
قال لي الرجل: الطعام يؤثر فيك جدا.. فقد كان أحد الرهبان في رحلة ونزل ضيفا على أناس في كوخ في طريقه هو ورفاقه لوجهتهم.. وأعجبه للغاية القدح الذي قدم له فيه مضيفوه الشراب.. فخبأه ضمن أغراضه بعدما تناول طعام العشاء ونام بعدها.. ثم خرج إلى وجهته.. وفي منتصف الطريق أحس بذنب شديد وبندم بالغ وسأله نفسه: كيف وأنا راهب أن أسرق؟ كيف أسرق الذين أطعموني واستضافوني؟!
فقطع رحلته وعاد قافلا إلى الكوخ.. وسأل الناس: من أين تحصلون على طعامكم؟ فقالوا له نحن لصوص! نسرق ما يتاح لنا ونأكل، فأدرك الراهب أنه حين أكل من طعام اللصوص صار لصا هو الآخر ونبتت في دواخله دواعي اللصوصية.
ساق صديقي الهندي هذه القصة ليدلل لي خطورة ما يأكله الإنسان وضرورة أن يحتاط للأكل الذي يأكله وأن يبحث في أصله.
رددت عليه بما أفهمه من تراث الإسلام عن ضرورة تحري الأكل الحلال وألا يأكل طعامك ألا مؤمن.. بينما طرقني مثاله أو حكايته الرمزية بكل عنف.. وأخذت أردد بيني وبين نفسي: من أكل طعام اللصوص صار لصا.

(4)
طبعا كل موقف في الهند تقريبا يحيلك إلى أسطورة وإلى حكاية وإلى ديانة وإلى معبود ما.
تنهدت وبدأت مهمتي في البحث عن آميتاب باتشان وخلطته السحرية، وأخذت أسأل عن الفيلم الذي يهيمن على وجداني من مجمل المكتبة الهندية التي استلبتنا في طفولتنا واشتهر لدينا بالاسم التجاري "صراع الجبابرة"، كنت أود أن أعرف اسمه الأصلي.. وبعد كر وفر وصولات وجولات وأنا أحكي أحداث الفيلم حتى يدلوني على اسمه.. عرفت أنه "جنجا.. جامونا.. سارسواتي".
ساعتها أحسست أنني أقترب من الظفر بمناي في فهم آميتاب باتشان وتأثيره علينا، الفيلم الذي جاء في نهايته الممثل الهندي الأشهر وهو يحمل فوق ظهره تمساحا ليصارع خاله الشرير، لم يكن كما كنت أفهمه في طفولتي وكما كنت أتصوره قبل السفر للهند.. فهو ليس مجرد قصة تراجيدية كلاسيكية، بل ترميز كامل لمعبودات الهند وقيمها وآلهتها ونظرها للإنسان وللخير والشر والعدالة.
فجانجا "آميتاب باتشان" بطل الفيلم يحمل اسم نهر الجانج أو الجانجا بنطقهم، وجامونا هي اسم النهر آخر شهير يلتقي معه، أما سارسواتي فهو اسم معبودة هندوسية"، والعلاقة بين الأطراف الثلاثة الذين يتقاسمون بطولة الفيلم.. مغموسة في الرمزية الدينية وتدور بين مطرقة الحق وسندان الشر.
تذكرت كيف كنا أطفالا متسامحين مع مشهد صلاة آميتاب باتشان للأفعى كي تساعده، وكيف أنقذ الأفعى ذات مرة من النيران لأنه اليوم المخصوص لها ولتقديسها.. وكيف يتمازج الإنسان مع الطبيعة وتتجاوب معه معتقداته.

مازلت أذكر صديقا لي في طفولتي وهو يحكي بحماس وتأثر عن الحية التي ساعدت البطل دون استنكاف عقائدي زاعق كالذي ستلقاه هذه الأفلام ربما لو عرضت اليوم.
كنا ننظر لها كجزء من العدالة الكونية، وكقصص أسطورية، لا كجسور عقائدية لتمرير عبادة كريشنا إلى قريتنا البريئة الطاهرة كما هو الحال مؤخرا للأسف!
انغمست في قصص أسطورية كثيرة تتخلل كل شيء في الهند، حتى أنني حين انتهيت من جلسة تعارف مع سيدات روسيات ورجل إنجليزي، ينتمي كل منهم إلى مؤسسة إعلامية بارزة في بلاده، وجئت لأخرج لتناول الغداء، اصطدم بي شاب هندي عملاق البنية وداس على رجلي، فوقف الرجل في وضعية الصلاة الشهيرة ليعتذر لي.
ساعتها تعطلت آلتي الإدراكية تماما، لم أفهم ما الذي يجري.. فهل تحولت إلى معبود محلي – كما حذرني أحد الأصدقاء متندرا- أم أن هذه هي صيغة اعتذار ما أم أن وقتا للصلاة لإله معين قد حان؟
قال لي الشاب أنه داس على قدمي بقدمه، وأن القدم أسفل جزء في جسم الإنسان ولا يصح أن تطأ إنسانا آخر ومن ثم فهو يعتذر لي، بينما يضم كلتا يديه إلى صدره وينحني أمامي بخشوع كما لو كنت إلها هنديا عتيقا.

ذهبت للغداء، ثم صادفت طاولة طعام ضخمة منصوبة قبالة القاعة التي كنا نجلس بها، وهي قاعة ضمن قاعات كثيرة تضم فعاليات كثيرة، فسألت الطاهي الذي يقف على رأس أواني الطعام، هل يحق لي الغداء معكم؟، فنظر إلى الهوية التي أعلقها على صدري وتشير لطبيعة مشاركتي ثم أومأ أن نعم.
انتهيت من الطعام وذهبت لمشرف الفعالية وأخبرته أن هناك طاولة طعام بالخارج للمشاركين لأنه فيما يبدو أن البعض لا يعلم، فقال لي هذه ليست مخصصة لنا.. بل لفعالية أخرى!.
سألته: أنا أكلت من هذا الأكل وهو ليس بحقي.. كيف يمكن أن أكفر عن هذا الخطأ؟
فابتسم وقال لي: نقول في الهند أن كل حبة طعام تخرج من الأرض وقد كتب الله عليها اسم الشخص الذي سيأكلها.. ومن ثم فإن اسمك مكتوب على كل حبة أكلتها.. فلا تقلق!
قلت له في مصر نقول: اللقمة بتنادي أكالها، ثم ابتسمت وتصالحت مع منطقه ومع حقيقة أنه لا حيلة لدي في التصرف بأثر رجعي.
وهكذا كل تفصيلة عادية في الهند قد تحيلك إلى شيء ما غيبي ضخم ومتشابك.
هذه المواقف البسيطة كانت تعمق فهمي لتفاصيل كثيرة اكتنفت أفلام آميتاب باتشان سواء "صراع الجبابرة" (وفقا للاسم التجاري)، أو "جبار سي" أو "قمر أكبر أنطوني".. وهي الأفلام الثلاثة التي أزعم أن أبناء جيلي يحفظونها غالبا عن ظهر قلب، فمشاهد الغناء والطعام والرقص والصلاة والمرض والقتال.. كلها محملة برموز وسياقات غائرة في العمق الهندي. ومن ثم انطبقت عليها القاعدة العالمية التي يعرفها كتاب الأدب " كلما أوغلت في المحلية.. أوغلت في العالمية".
(5)
في أوبر، كنت أردد الشهادتين طيلة الوقت، فالهند واحدة من أكثر الدول في العالم إثارة للفزع لو أنك تقود فيها سيارة.

وتذكرت سلسلة حلقات عالمية عن القيادة الخطرة التي تكسر كل القواعد، والتي أدرجت حلقة عن مصر بالمناسبة، لكن حلقة مصر تنحت في الترتيب وتنحت مصر نفسها في الترتيب مقارنة بحلقة الهند.
فقيادة المركبات هنا والوصول إلى الوجهات المختلفة، ليست مسألة تتعلق بالطرق والسيارات والبنزين وقواعد المرور.. بل أمر يدخل في نطاق اللطف الإلهي البحت.
وتحديد أجرة أوبر مسألة غيبية هي الأخرى تقريبا! فقد تدفع في المشوار الواحد رقما بعينه أو ضعفه أو ثلاثة أضعافه.. كما لو كنت في فانتازيا دائمة الانعقاد وكما لو لم يكن هناك قاعدة للالتجاء إليها حكما فصلا، لا المسافة ولا التوقيت من اليوم ولا درجة الازدحام المروري هي الحكم بالضرورة.. ربما هي لجنة عليا من آلهة الهند.
في الطريق كنت أصادف أبقارا ضخمة مطلوقة بحرية في شوارع العاصمة، وهي جزء من هوية الهند وأزماتها في نفس الوقت، إذا اضطرت الحكومة لتحديد ما سمي بالحزام البقري لتحييز أماكن لا يقترب فيها البشر من البقر، وفي عدد من الولايات يحق لعدد من المسالخ والمذابح ذبح البقر وطهوه، لكن البقر يصاب بنوبات جنون حين يكبر سنه ولا يجد احتياجاته فيهاجم القرى ويقتل المواطنين، لكن المسألة تدور في فلك حسابات عقائدية بين ديانات تقدس البقر وديانات تبيح الغداء بها ومواطنون يشكلون سدس كوكب الأرض.. بينما وراء كل منهم "فيلم هندي" إذا ما توغلت معه في الكلام.